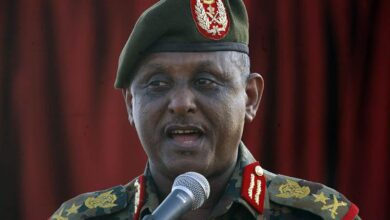لا أعرف مسألة ارتكبناها أشنع من خوضنا بدون علم في موضوع هوية السودان بين العروبة والإسلامية من جهة والأفريقية من الجهة الأخرى. فقد ركبناه “عري” في لغة الريف. وهو ركوب الدابة بغير سرج. وقلت في مرة سابقة إننا أحسنا القتال حول تلك الهوية بالسلاح بينما اعتورتنا الخيبة ونحن نتجادل فيه بالعقل. فاستخدمنا آخر صيحات السلاح من راجمات وغيرها في قتالنا حول الهوية بينما دخلنا حومة الوغى الفكرية بنظريات صدئة أو جزافية.
ثار الخلاف الواسع حول “عروبة وإسلام” السودان وأفريقيته في الوقت الذي لم تعد لهذه المصطلحات أو الهويات وثوقيتها التي زعمتها صفوتنا. فبينما تنازعنا حول عروبة السودان وأفريقيته كان علماء الثقافة قد تساءلوا إن كنا نعرف حقاً ما نعنيه حين نصف الشيء ب”العربي” أو “الأفريقي”. فقد غشاهم الشك إن كان لهذه الهويات معن جوهرياً لا يتبدل أو يتغير.
وساهم كتابان منيران في إذكاء جمر الشك في حقائق العرب والسلام وأفريقيا وهويتها. الكتاب الأول لإدورد سعيد وهو “الاستشراق” (1978) الذي جدد معرفة الغرب بالإسلام والعرب كما لم يفعل كتاب آخر. أما الكتاب الثاني فهو “اختراع أفريقيا” (1988) للكنغولي ف واي موديمبي. وصوب الكتابان نيرانهما إلى العلم والشوكة الأوربية التي انتجت لنا صوراً “REPRESENTATION” نتداولها عن الشرق وأفريقيا كمعرفة لا يأتيها الباطل. جادل سعيد بقوة أن منتهى علمنا بالشرق (عربه ومسلميه) ليس هو الشرق بل ثمرة لخطاب الاستشراق. وهو خطاب أصله في شوكة أوربا. وتنامى هذا الخطاب منذ القرن الثامن عشر وأنتج معرفة منظمة بالشرق تقوت بخضوعه للاستعمار علاوة على الولع الغربي ب”غموض” الشرق و”غرائب” طباع أهله التي أصبحت موضوعاً لعلم التاريخ واللغات والقصة والفنون والأنثروبولوجيا. وظل مدار هذه المعرفة هو تضاد القطبين “الشرق” و”الغرب” فما يصح في الواحد خلاف ما يصح في الآخر. وخلص سعيد إلى أن الشرق الذي نعرفه في أدب الغرب هو شرق “تشَرَّق” بفضل غلبة أوربا عليه. فهو خطاب واحد من عدة خطابات محتملة لو لم تغلب أوربا على الشرق وتحتكر إنتاج المعرفة عنه.
يعتقد موديمبي من الجهة الأخرى أن أفريقيا التي معرفتها بيدنا هي “اختراع” أوربي. فنظر إلى الحالة الأفريقية من موقعه، كأفريقي، في هامش المعارف العديدة عنه وعاها الأوربيون وكتبوها لمجرد غلبتهم على الأفريقيين.
ركز موديمبي على الكشف عن النطاق المعرفي الذي نجم عنه خطاب بعينه عن أفريقيا في وقت بذاته، ومكان بعينه. فهو يرى أن هذه الخطابات نشأت جميعها حتى وقت قريب من خارج أفريقيا وفي أوربا تخصيصاً. وهي خطابات شديدة الارتباط بتاريخ التوسع الأوربي وطلب أهلها الشوكة الإمبريالية. بمعنى آخر فهذه الخطابات تساوقت مع تجارة الرقيق، والغزو الاستعماري، والتبشير المسيحي. فالممارسة الباكرة لعلم الأنثروبولوجيا في مركز الدائرة من المغامرة الأوربية الاستعمارية في أفريقيا.
ولربما تخطى الخطاب الأوربي الآن مصطلحه الباكر من مثل وصفه الأفريقي ب “التوحش”. لكننا لو فحصنا خطاب الغرب عن التنمية لوجدناه يرجع بنا إلى التراث الخطابي لأوربا المشدود بين “نحن و” هم”. فالأفريقي “متوحش” والأوربي “متحضر” وقس على ذلك. فخطاب التنمية المتداول حالياً يصور الأفريقي أيضاً ك “متخلف” بينما يصف الأوربي ب”المتطور”.
أراد موديمبي بكتابه أن يستعيد الأصوات الأفريقية التي أضاعتها ثنائيات الخطاب الأوربي: “ألأنا” و”الآخر” حتى تقع لنا معرفة بأفريقيا أدنى للأفريقيين أهلها. فوجد هذه الثنائية متمكنة في دراسة الأدب الأفريقي. فهذا الأدب “شفاهي” بينما أدب أوربا “مكتوب”. وبررت هذه الثنائية لأوربا الاستخفاف بالنص الشفهي ونظرت إليه كحامل لتجربة ثقافية وحيدة الجانب في حين أنه النص المغموس في التجربة الإفريقية الحق.
ونظر مودمبي إلى العلاقة بين المعرفة العلمية الأوربية و”الحكمة الأفريقية” (اي المعرفة الأفريقية المحلية). ورأي في معرفة أوربا العلمية شوكة فَشت وغبَّشت حقيقة الخطابات الأفريقية الأرومية (من أرومة) في تجلياتها من جهة الاختلاف والتنوع. ولذا سعى مودمبي إلى كسر الفاصل المفتعل بين الفلسفة وحكمة أفريقيا. فهناك من عرَّفوا الفلسفة بأنها خطاب ناقد لذاته ذاتها بصورة واعية بينما مال آخرون إلى القول إنها جسد من النصوص وخطابات فلسفية المنحى. وأختار مودمبي التعريف الأخير ليسترد للأصوات الأفريقية اعتبارها من ازدراء التعريف للفلسفة كنشاط واع بنفسه.
ونظر مودمبي للعلاقة بين التاريخ والاسطورة أيضاً ليرد الاعتبار للأصوات الأفريقية المغيبة في خطاب أوربا بينما كل منطق عذا التغييب هو شوكة أهله لا الحق. فَفَتش في الأسطورة عن “الذرة الأسطورية” أي الوحدة الصغرى التي تنبني عليها الأسطورة ليقارن بين هذه الوحدات في أساطير أفريقيا والأساطير الأخرى. فهذه الوحدات الأسطورية موتيفات عالمية ترد في القصص الأسطورية في سائر بلاد العالم في ثقافات مختلفة. ويضيف إنه إذا كان “الخلاص” كوحدة أسطورية هو موتيف عالمي وجب أن نحلل نسخ هذا الخلاص المختلفة في أفريقيا والمسيحية وغيرها بصورة لا تميز المسيحية عن غيرها.
وموديمبي يري الأسطورة تاريخاً والتاريخ أسطورة حتى لا يكون التاريخ، الذي هو احتكار أوربي، أميز من الأسطورة الأفريقية. فالأسطورة عنده ذاكرة جماعية، أو أنها سيرة ذاتية شاملة للجماعة. أما التاريخ فهو تمرين له وعي بذاته ومشغول بطرائقه المنهجية يواليها بالدرس ويتدرب المؤرخون عليها. وعليه فهما شيء واحد مؤد إلى استحضار للماضي. وليس الحق في جانب من أرخص بالأسطورة ليميز التاريخ. فمجال هذا التمييز الأخرق ليس في قيمة كليهما من جهة المعرفة بالماضي بل في لأت أهل التاريخ كانت لهم الغلبة والشوكة على من تاريخهم هو الأسطورة. ونشأ هذا الإرخاص بالأسطورة من استوهام أوربا بأهميتها ومن حقيقة إن الأوربيين سادوا في الخطاب عن أفريقيا وشكلوه.
من أسف أن الكتابين لم يجدا سبيلهما إلى جدلنا حول الهوية السودانية. فقد تحدثنا عن “جوهر” للإسلام أو العروبة أو الأفريقية بوثوق لا سند له في علاقة القوة بالمعرفة التي عالجها كتابا سعيد ومودمبي. وخلصا منها إلى أن أكثر حديثنا عن تلك الهويات هو اختراع، أو أكاذيب، ثقافة ل أو عن ثقافة أو ثقافات أخرى. ربما لهذا السبب كان مصطفي سعيد عند الطيب صالح يقول: “أنا اكذوبة” لأنه يعرف أنه لا سبيل له لعرض نفسه على العالم كما يريد بغير سلطان أوربا وخاتمها.
* استعنت بمقال جيد للبروفسير لويس بيرنر في عرض كتاب “اختراع افريقيا”.
_______________________________________
للتفاعل مع الكاتب